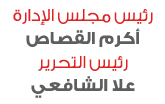راسبوتين، جريجورى راسبوتين، الراهب الأكثر ورعا فى روسيا حتى 1915، والأكثر شيطانية منذ 1916 حتى الآن، لم يتألّه بورعه وشهرته ليصعد سلّم القداسة متجاوزا المسيح، ولم تهبط المسيحية معه فى المستنقع الذى سقط فيه، باختصار عاش الرجل تقيا ومات فاسقا، دون أن يراه محبّوه أقدس من الدين، أو يراه كارهوه تشويها للدين.
راسبوتين فلاح عادى من سيبيريا، دخل الدير هاربا من اتهام بالسرقة، بعدما ترك خلفه زوجة وأربعة أبناء، ومن هذه المحطة بدأت شهرته كرجل تقى وصاحب قدرات خاصة فى الشفاء والبركة، لينجح فى العام 1909 فى الوصول إلى مدينة "سان بطرسبرج" ودخول قصر القيصر نيقولا الثانى، بعدما أنقذ ابنه من الموت، ليعيش السنوات السبع التالية وجيها ومطلوبا من علية القوم لبركته، ومقدّسا من عامة الناس لما شاع عن رهبانيته وتقواه، ومع ذيوع شهرته زاد أعداؤه، وبدأ تتبّعه واكتشاف سقطاته، وانقلب عليه راهب وأسقف من أتباعه السابقين، وتحالفا مع عدد من النبلاء ضده، حتى تمكنوا من قتله لاحقا بعدد من الرصاصات، بعدما فشلت عملية التخلص منه بالسم بسبب قوته البدنية، لتنتهى أسطورة "راسبوتين" فى ديسمبر 1916، قبل 10 شهور من الثورة البلشفية، وتنقضى حالة القداسة التى شاعت عنه فى أروقة العامة والنبلاء، ويعود لموقعه الطبيعى فى نظرهم، إنسانا عاديا فى وجه، وشيطانا رجيما فى وجوه.
بالطبع لا أقارن الشيخ محمد متولى الشعراوى بالفاجر "راسبوتين"، ولا أقول إن السياقات متشابهة، ولا أنكر على "الشعراوى" جهده فى التفسير اللغوى والبلاغى للقرآن، ولكن استدعاء هذه القصة هدفه الوحيد تأكيد أن تقديس البشر فعل يُودى بنا إلى ما لا يُحمد، وانتقادهم - سواء كانوا صالحين أو فاسدين - لا يخصم من إنسانيتهم، ولا يطال الدين نفسه فى شىء، ولكن ما حدث مؤخرا من اتهام للكاتبة فريدة الشوباشى بازدراء الإسلام، بعدما انتقدت الشيخ، يشير إلى خلل كبير فى رؤيتنا لـ"الشعراوى"، الإنسان والمفسّر، وفى رؤيتنا للدين الثابت المؤيَّد من الله والمنقول عن قرآنه وصحيح سنة رسوله، ومن المؤسف أن نتورط فى اختزال الإسلام فى شخص أيا كانت قيمته، وأن نعتبر انتقاد إنسان، له ما له وعليه ما عليه، ازدراء لدين عظيم وراسخ، ومن يسلك هذا المسلك فى تصورى هو من يزدرى الإسلام، بتقزيمه وحصره فى شخص أيا كانت أهميته، وحتى لو كان على هذه الأهمية إجماع.

الشعراوى لم يطلب القداسة.. وفريدة الشوباشى لم تزدرِ الإسلام
عاش محمد متولى الشعراوى، المولود فى 1911 والمتوفّى فى 1998، حياة طويلة وحافلة بالمشاهدات والمواقف، بدأ من التعليم الأزهرى المتوسط، ثم التحق بجامعة الأزهر، واشتغل بالتفسير والدعوة حتى لقى ربه، ومن محطة الطفولة والشباب حتى آخر أيامه، تبدلت مواقف الرجل وانحيازاته عشرات المرات، بحسب الثابت من مذكراته التى أملاها على الكاتب محمد زايد ونُشرت عن دار الشروق بعد وفاته بعشرة أيام تحت عنوان "مذكرات إمام الدعاة"، وبحسب حلقاته التليفزيونية ولقاءاته وحواراته ومقالاته وما رواه لآخرين.
.png)
بدأ الرجل رحلته العامة عضوا بجماعة الإخوان، ثم عضوا بحزب الوفد فى الوقت نفسه، ووصل لمنصب وزير الأوقاف فى سبعينيات القرن الماضى، ثم تفرغ وابتعد عن العمل العام مكتفيا بتفسير القرآن ونشاطه الدعوى، وطوال هذه الرحلة لم يُؤثر عن الرجل أنه طلب القداسة، أو ادّعى أنه فوق النقد، بل إنه وثق بنفسه عن نفسه أنه شاهد أول فيلم مصرى فى السينما، فيلم زينب، بتذكرة مجانية من مؤلفه الدكتور محمد حسين هيكل، وتساءل عن حرمة الفن وقتها، وحاول دق وشم على وجهه فى شبابه، ومدح ملوك ورؤساء وأمراء، وهاجم آخرين، وأفتى بأمور وتراجع عنها، وأفتى بغيرها ولم يطبقه، وفى كل هذا كان يتحرك وفق ما سمح له القدر والطاقة التى منحها الله لإنسان عادى، ولم يدّع يوما أنه استثنائى أو غير عادى، وربما تكون القداسة المبالغ فيها الآن تعذيبا للرجل وتحميلا له فوق طاقته.
ما قالته الكاتبة الصحفية البارزة فريدة الشوباشى مؤخرا، من أنها صُدمت وطنيا وآذاها ما قاله الشعراوى عن سجوده شكرا لله عقب هزيمة 5 يونيو 1967، ليس أمرا جديدا ومُحدثا، والسيدة ليست أول من يستعيده وينتقده، والموقف أصلا سجله الشيخ الشعراوى بنفسه وذكر له تبريرا لم يُقنع كثيرين، وفى كل الأحوال لا يطال الأمر الإسلام فى شىء، ولا يعدو كونه تقديرا لموقف عادى من إنسان عادى، حتى وأنت تراه موقفا خاطئا، هو مجرد موقف، لا يمثل ازدراء للإسلام كما قالت أسرة الشعراوى فى بلاغها للنائب العام ضد فريدة الشوباشى، ولا يمكن لفقيه أو عالم، أو مجرد شخص عاقل، ادعاء أن هذا الانتقاد يُخرج من الملة، أو حتى يقع فى دائرة السب والقذف والنَيل من الأشخاص، لأننا أمام موقف موثق على لسان صاحبه فى النهاية، والاختلاف فى تقديره، واقتناع البعض بما ساقه الشيخ من مبررات أو رفضها، كلها تقع فى أمور التفاوت النسبى الذى لا يحمل أى تجاوز فى حق الشيخ أو القانون أو الدين، وربما يكون إخفاؤه هو التجاوز الحقيقى فى حق التاريخ وقراءته بموضوعية ومن أفواه أصحابه.
الشعراوى.. رحلة الإنسان من العادية إلى القداسة الإجبارية
تخرج الشيخ محمد متولى الشعراوى فى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فى العام 1940، ثم حصل على شهادة العالمية وإجازة التدريس، ليعمل لاحقا مدرسا فى قطاع التعليم الأزهرى، أى أننا أمام رجل تخصص فى اللغة العربية بالأساس، وليس فى الفقه أو التفسير أو العقيدة، وما لحق هذا من اطلاع ودأب ومعرفة ونقل للمعرفة، اجتهاد من صاحبه، لا يميزه على اجتهاد أى شخص آخر سعى للتعلم وزيادة حصيلته من المعرفة.
انضم "الشعراوى" لجماعة الإخوان فى وقت لاحق لتأسيسها، وكان من المقربين من مؤسسها حسن البنا، وبحسب مذكراته فقد كتب بنفسه أول بيان للجماعة، ولكنه فى الوقت نفسه كان عضوا فى حزب الوفد الليبرالى الذى يقف على مساحة عداء محتدمة وجذرية مع الإخوان، ويحكى الشعراوى أنه حضر فى العام 1937 حفلا لإحياء ذكرى مؤسس الوفد والزعيم الوطنى الكبير سعد زغلول، وقال قصيدة فى مدحه، ولهذا السبب اختلف معه حسن البنا.
.jpg)
بعد مرحلة الوفد الطويلة، قاطع الشعراوى الأحزاب مجبرا كغيره من المصريين، بعد قرار ثورة يوليو بحل الأحزاب وإنهاء الحياة الحزبية، ثم انضم فى سبعينيات القرن الماضى لحزب مصر العربى الاشتراكى، الذى أسسه السادات قبل الحزب الوطنى الديمقراطى، وتقول بعض الشائعات إنه انضم لاحقا للحزب الوطنى نفسه، ولكن سأعتبرها من قبيل الشائعات المكذوبة، وسأكتفى بعضويته فى حزب مصر العربى، التى حصل بموجبها على مساحة شديدة من القرب للرئيس الراحل محمد أنور السادات، ثم منصب وزير الأوقاف بين العامين 1976 و1978، ولكن الرجل نفسه قال فى حواره مع مجلة "صوت الجامعة" الصادرة عن جامعة القاهرة فى العام 1993: "أنا لا أدخل حزبا إلا فى دولة قالت أنا أوظف الإسلام، أنتم تطلبون كلمة الدين فى دولة لا توظِّف الدين، ولمّا يبقوا يسألونى عن الحكم أبقى أقول لهم".
.jpg)
فى الموقف السابق ومواقف أخرى عديدة، يمكن اقتناص شواهد وقرائن على شىء من التناقض فى بعض مواقف الشعراوى، باعتباره إنسانا عاديا يجتهد، ويقف دائما عُرضة لاحتمالات الإصابة والخطأ كغيره من الناس، ولعل الرجل نفسه كان متصالحا مع هذا الأمر ويتنقل فى مواقفه وانحيازاته مقتنعا بنسبية الأمور وأنه ليس ملاكا ولا مطلوبا منه أن يصيب دائما، فمن أين إذن جاءت القداسة التى لم يطلبها؟ الحقيقة أن الأمر ربما يعود إلى التطوع المجتمعى والهالة التى رسمها العاديون والطيبون حول الرجل الذى طالما استمعوا للقاءاته وحلقاته لتفسير القرآن، التى أوصل لهم فيها رسالة الله بطريقة مبسّطة وسهلة، ربما يمكن تسجيل بعض الملاحظات عليها، ولكنها كانت تستهدف تقريب القرآن من صدور وعقول المؤمنين به، ولأن الجمهور الواسع الذى تربّى على هذه اللقاءات لم يلتق الشعراوى، ولم يقرأ عن حياته، ولم يهتم بتاريخه وسيرته فى الحياة، فلم ير من الرجل إلا هذا الجانب النورانى، ومع توالى الأيام اختزل الوعى الجمعى شخصية الرجل بتركيبها وثرائها وإنسانيتها المتراوحة بين المواقف الصائبة والمخطئة، فى هذا الوجه الواحد، ولأن القرآن مقدس، تورط المحبون فى سحب هذه القداسة على من رأوه حاملا للقرآن ومبشرا مُيسِّرا لرسالته، ليتورطوا شيئا فشيئا فى جعل الشعراوى بإنسانيته معادلا للقرآن بقداسته، ويتحول الأمر فى عقولهم لاحقا إلى تفسير انتقاد الرجل أو الاقتراب من سيرته، باعتباره اقترابا من القرآن وطعنا فى قداسته، وهو ربط ضار بالشعراوى نفسه، فضلا عن ضرره بعقائد معتقديه وأفهام فاهميه، وبالسياق العام لمجتمع يسعى للتدين على بصيرة.
.jpg)
هل قراءة مذكرات الشعراوى واستعادة ميراثه يُخرجان من الإسلام؟
الحقيقة التى لا يمكن تجاهلها فى أى طرح موضوعى، أن محبى الشعراوى لهم فى الرجل ما سجّله من معرفة، اجتهد قدر طاقته لتكون تعبيرا عما يراه حقا وصوابا، والله أعلم بالنوايا، ولكن هناك من يهتمون بما هو أبعد، ربما يشتبك بعضهم من الدارسين والباحثين مع بعض أفكار الرجل وفتاواه وتفسيراته، وربما يهتم آخرون باستعادة سيرته ودراسة تاريخه، لفهم بواعث أفكاره ومواقفه، باعتبار الفكرة والموقف لا ينفصلان عن المثيرات الاجتماعية والظروف التى أنتجتهما، والاحتجاج على السائرين فى هذا الطريق بأن مسلكهم فيه انتهاك لعصمة الميت، وأن الأفضل أن يذكروا "محاسن موتاهم"، فيه قدر ضخم من التبسيط، أولا لأن الأمر يدور حول دراسة السيرة والتاريخ وفق المعلومات والمصادر الموثقة، وثانيها أن الشعراوى ليس شخصا عاديا ممن تنقضى حياتهم بانقضاء أجلهم، وما زال خطابهم باقيا ومؤثرا، وما زلنا فى حاجة لفهمه وتحليله، ولن نصل لفهم وتحليل موضوعيين دون قراءة سياق حياة الرجل.
هل لو فتحت "يوتيوب" أو أرشيف بعض الصحف، واستعدت مواقف موثقة للشيخ محمد متولى الشعراوى، أكون متورطا فى انتهاك لحُرمة الميت وخارجا عن الدين؟ إذن لماذا يدرس طلاب الأزهر علوم الحديث، وفيها علم الرجال، الذى يصنف طبقات الرواة والمحدثين عن الرسول وصحابته، ويقيّمهم بمراتب بين العدل الصدق والكذب والتدليس والتسوية وغيرها من الدرجات والرتب؟ هل حينما قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعلى بن عبد الله بن عباس، إن "عكرمة" مولى عبد الله بن عباس وراويته الأشهر، كاذب وكان صفريا ومن الخوارج، كان هذا نَيلا من الإسلام أو انتهاكا لعصمة الميت؟ ويمكن تعداد مئات الأمثلة التى تتضمنها كتب التراث وتحمل إعادة قراءة لتواريخ الناس وأفكارهم وتقييمهم ووصفهم بأوصاف ربما لا تجوز فى حق العامة، ولكن هذا حق العلم على الشخصيات العامة، وكما قال ابن حزم الأندلسى: "من يتصدر لخدمة العامة فلا بد أن يتصدق ببعض من عرضه"، والثابت قطعا أن ما يجوز على العامة لا يجوز على الشخصيات العامة التى تظل حيّة بعد وفاتها، ويظل خطابها قائما وممتدا، وعلينا التفاعل والاشتباك معه.
.jpg)
فى 20 مارس 1978 استُدعى الشعراوى لمجلس الشعب، وكان وزيرا للأوقاف وقتها، وسبب استدعائه استجواب من النائب عادل عيد اتهمه فيه بالتهاون مع الفساد فى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال فيه: "لقد قصّر الوزير الشيخ الشعراوى فى استخدام حقوقه الدستورية والقانونية فى مواجهة شخص تابع له ولوزارته، واكتفى بإرسال شكوى لرئيس الوزراء"، تصاعدت حدّة المناقشات حتى وصل الشعراوى فى رده إلى محطة الرئيس السادات، قائلا عنه: "والذى نفسى بيده، لو كان لى فى الأمر شىء لحكمت للرجل الذى رفعنا تلك الرفعة، وانتشلنا إلى القمة، ألا يُسأل عما يفعل"، مستخدما الوصف الإلهى التوقيفى الذى وصف الله نفسه به فى حديثه عن السادات، هنا رد عليه عضو المجلس الشيخ عاشور محمد نصر: "اتق الله يا رجل.. مفيش حد فوق المساءلة.. لترع الله"، فانفعل الشعراوى ورد صارخا: "اجلس.. أنا أعلم بالله منك"، وفى اليوم التالى أسقط المجلس عضوية الشيخ عاشور، ولاحقا برر الشعراوى الأمر تبريرا لغويا، باعتبار "لو" حرف امتناع لامتناع، ما يعنى أنه يمتنع عليه أن يكون له من الأمر شىء ليضع السادات فى هذا الموضع الإلهى المعصوم والمنزه عن السؤال، ولكن حتى هذا التبرير اللغوى لا ينفى بنية الجملة اللغوية التى تقر قبوله للفعل وإن كان يمتنع عليه، أى أنه لا يستطيع فعل هذا، ولكنه يقبل فعل هذا.
.jpg)
هل لو استعدت الموقف السابق أكون مهينا للشعراوى وخارجا على الإسلام؟ وهل لو استعدت مثلا أنه حرّم نقل الأعضاء البشرية حتى لو كان الأمر إنقاذا للحياة، تحت دعوى أن هذه العمليات تتحدى إرادة الله فى اختبار الناس بالمرض وتحاول التحايل على الآجال، لكنه هو نفسه سافر إلى لندن للعلاج ونقل الدم وزراعة "قرنية"، أكون أهين الرجل وأنتقص منه ومن الإسلام؟ أم أستعيد سيرة وتاريخا موثقا، وحدثا مفصليا مهما للغاية فى فهم فتوى الرجل التى منعت كثيرين من العلاج، وربما مات بسببها كثيرون، ولكنه شخصيا لم يلتزم بها؟
سجد الشعراوى فى النكسة.. فلماذا نتجاوز السجدة ونُحاسب من يتحدث عنها؟
الموقف الذى انقلبت الدنيا فيه على فريدة الشوباشى، كان حديثها عن موقف الشيخ الشعراوى من نكسة يونيو 1967، قالت السيدة إنها تأذت نفسيا ووطنيا مما قاله الشعراوى بنفسه عن رؤيته لهزيمة مصر القاسية قبل خمسين عاما من الآن، فما المهين فى أن نستعرض موقفا حكاه صاحبه، وننقل شعورنا بشأنه؟ أليس الموقف نفسه كان تعبيرا من صاحبه عن شعور تجاه حدث؟ وهل لو كان التصرف خاطئا علينا أن نتجاهله ولا ننتقد خطأه، ليطلع عليه شاب قليل الخبرة ويقلده أو يكرّره، بما يحمله من زلزلة وتفسخ للمشاعر الوطنية؟
فى الحلقة الأولى من برنامج "من الألف إلى الياء"، الذى كان يقدمه الإعلامى طارق حبيب فى ثمانينيات القرن الماضى، سُئل الشعراوى عن استقباله لخبر نكسة يونيو 1967، فقال الراجل بوضوح إنه استقبلها بالسجود شكرا لله، وكان مبرره: "فرحت لأننا لم ننتصر ونحن فى أحضان الشيوعية، لأننا لو نُصرنا ونحن فى أحضان الشيوعية لأُصبنا بفتنة فى ديننا، فربنا نزّهنا"، وهنا يحق لكل شخص أن يرى الموقف وفق تصوراته، أنا شخصيا أراه مؤذيا للمشاعر الوطنية، ففضلا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم"، لا يمكن عقلا أو منطقا قبول القصاص من النظام السياسى الذى نختلف معه أو نراه مرتميا فى أحضان الشيوعية، على حساب آلاف الشهداء والمصابين والأسرى والجنود والضباط الذين عادوا من سيناء حفاة عراة.
ابتهاج الشيخ الشعراوى بهزيمة يونيو 1967 حتى لا تنتصر الشيوعية ونُفتن فى ديننا، كان ينسجم تماما مع موقف الرجل الذى رواه فى مذكراته من عبد الناصر، إذ قال إنه كتب تحت صورته فى مكتب شيخ الأزهر الشيخ عبد الرحمن حسن: "غدًا تتوارى فى سراديب من مضى/ ويمضى الذى يأتى لسردابكم حتما"، ولكن الرجل نفسه بعد أقل من ثلاث سنوات، كتب تأبينا لجمال عبد الناصر المتوفّى فى أواخر سبتمبر 1970: "مات جمال وليس بعجيب أن يموت، فالناس كلهم يموتون، ولكن العجيب وهو ميت أن يعيش معنا، وقليل من الأحياء يعيشون، وخير الموت ألا يغيب المفقود، وشر الحياة الموت فى مقبرة الوجود، وليس بالأربعين ينتهى الحداد على الثائر المثير، والملهِم الملهَم، والقائد الحتم، والزعيم بلا زعم، ولو على قدره يكون الحداد لتخطى الميعاد إلى نهاية الآباد، ولكن العجيب من ذلك أننا لو كنا منطقيين مع تسلسل العجائب فيه لكان موته بلا حداد عليه، لأننا لم نفقد عطاءنا منه، وحسب المفجوعين فيه فى العزاء، أنه وهو ميت لا يزال وقود الأحياء".
إلى جانب موقف الشعراوى المتداخل وغير المفهوم من نظام جمال عبد الناصر وشخصه، فى أقل من ثلاث سنوات، كتب الرجل مقالا فى صحيفة الأخبار فى 12 يونيو 1984 بعنوان "الإسلام يتحدى الشيوعية والرأسمالية معا"، مستعرضا فيه أن الإسلام فكرة قائمة بذاتها تصطدم مع الشيوعية والليبرالية، ولكنه فى الوقت ذاته كان عضوا فى حزب مصر العربى الاشتراكى، القريب من الفكرة الشيوعية، وقبلها كان عضوا فى حزب الوفد الليبرالى "الرأسمالى" كما أشرنا من قبل، وقال فى قصيدة عن الوفد وسعد زغلول سنة 1943: "ودمت يا ذكر سعد ملهبًا أمما/ يسعى إلى مجدها النحاس والوفد".
قصائد الشعراوى فى مديح الملوك والأمراء والسياسيين
فى أغسطس 1993 أجرت صحيفة الأخبار حوارا مع الشيخ الشعراوى، قال فيه عن حديث "السلطان ظل الله فى الأرض" إن على العلماء التبيّن والتثبت، منتقدا الحديث ومعتبرا إياه غير صحيح، لكن هو نفسه كتب قصيدة يمدح فيها الملك فهد بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين وقتها، قال فيها: "يا ابن عبد العزيز يا فهد شكرًا/ دمت للدين والعروبة فخرًا.. أنت ظل الله فى الأرض/ تحيا بك البلاد أمنًا وسرًا.. أنت زدت المقدسات شموخا".
باب المدح فى حياة الشيخ الشعراوى كان بابا عريضا ولا يمكن العبور عليه دون توقف، علاقة الرجل كانت جيدة بكل الحكام والوجهاء والمشهورين وأصحاب السلطة والنفوذ، وكما امتدح سعد زغلول وجمال عبد الناصر والسادات، مدح النحاس باشا وحسن البنا، ومدح الملك فهد بن عبد العزيز، والملك عبد العزيز آل سعود، وعددا من الشيوخ والملوك والأمراء العرب من دول عدّة، وقال فى لقاء مسجل مع مبارك عقب نجاته من محاولة اغتياله فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى 1995: "اللهم إن كنت قدرنا فليوفقك الله، وإن كنا قدرك فليعنك الله على تحملنا"، فى دعوة غريبة وتحتاج للتوقف والتحليل، إذ اشتملت فى جانبيها على الدعاء لمبارك، لا الشعب، حتى لو كان ولى الأمر قدرا صعبا أو قاسيا، أو كان الشعب ليّنًا أو مهيض الجناح، فى الحالتين التوفيق والسداد والتحمل والعون كانت أمنيات الشيخ للرئيس وحده.
.jpg)
هل نصبح كافرين إذا ذاكرنا سيرة الشيخ الشعراوى ورحلة حياته؟
أمر مقلق أن تجد نفسك متهما بازدراء الإسلام، لا لأنك طعنت فى نص مقدس، أو نفيت حكما شرعيا، ولكن لأنك اقتربت من سيرة حياة بشرية، واستعرضت الثابت منها، وما قاله صاحبها بنفسه أو سجله بالصوت والصورة وبالكلمة والقلم.
لا أفهم ما الغضاضة إذا خرجت فريدة الشوباشى أو أى شخص غيرها، وقال إن الشيخ الشعراوى قال فى حوار مع الكاتبة سناء السعيد، صدر فى كتاب "الشعراوى بين السياسة والدين" الصادر عن دار الفتح للإعلام العربى فى العام 1997، قبل وفاة الشيخ، إنه يرفض عمل المرأة ويتهمها بهدم المجتمع لا بنائه، أو بنص قوله: "خروج المرأة للعمل هروب من مهمتها الأصلية، وهى تربية الأبناء، النساء يخرجن لهدم المجتمع لا لبنائه، وإذا أقبل الرجل على امرأة لكى تعاونه فى حياته، فهذا سبب كافٍ لردع المرأة عن أن تقبله كرجل"، وأنه قال أيضا فى حوار مع مجلة "صوت الجامعة" فى فبراير 1993: "وجود الطالبات مع الطلاب حرام، ما تقولّيش اختلاط وبعدين تسألنى عن حدود العلاقة، لأن وجودهم مع بعض من الأول حرام"، وقال أيضا فى حلقة من برنامجه "خواطر إيمانية" فى العام 1984: "المرأة يجب أن تكون مستورة حتى لا يشك الرجل فى بنوّة أبنائه منها"، متهما بشكل ضمنى كل السيدات غير المحجبات بأن أعراضهن محل شك وأنهن لا يصلحن للأمومة ومتهمات فى شرفهن، هكذا على الإطلاق ودون حجة أو تبرير، بينما كان معروفا عن الشيخ أن صداقة قوية ووطيدة جمعته بالفنانة الراحلة تحية كاريوكا، والفنانة المعتزلة شادية، وأنه كان يحضر ندوات وجلسات مع السيدة جيهان السادات والسيدة سوزان مبارك وصديقاتهما، وأن صحافة الثمانينيات والتسعينيات تحدثت عن شائعة زواجه من الفنانة شادية، وسواء كان الأمر حقيقيا أو لا، فالشيخ الشعراوى لم يكن ضد الاختلاط عمليا، بينما رفضه نظريا، فما الإهانة والازدراء فى استعراض هذه المواقف الموثقة؟
.jpg)
ما الإهانة فى أن نستعيد رأى الشيخ الشعراوى وفتاواه بتحريم فوائد البنوك بدعوى أنها ربا، وهى فوائد لا تتجاوز 10% سنويا، وأن نستعيد أيضا إباحته لفوائد شركات توظيف الأموال التى ظهرت أواخر السبعينيات وازدهرت طوال عقد الثمانينيات، وكانت تصل إلى 30 و40%، وعمل مستشارا لبعض هذه الشركات، وروّج لها، ووضع جزءا من أمواله فيها، وهى الشركات التى نهبت مئات الملايين من أموال المصريين وبسطاء المودعين، ولم ترحم صحافة الثمانينيات والتسعينيات أيا ممن ساعدوا هذه الشركات أو تعاونوا معها أو روّجوا لها وقدموا لأصحابها المشورة، ومنهم الشعراوى، من النقد والاتهام بالمساهمة فى ضياع أموال المصريين، فهل فى استعادة هذا التاريخ إهانة للشيخ الشعراوى؟ أم أنها جزء من تاريخه وتاريخنا وتاريخ ملايين المصريين؟ فى الحقيقة أنتظر إجابة فعلا، لأننى أستغرب المواقف الداعية لوأد التاريخ، بينما لو كان الشيخ حيا لحاورناه وسألناه وأجاب، كما أجاب على سؤال طارق حبيب حول سجوده فى نكسة يونيو.
ماذا لو تجاهلنا التاريخ وتورط فيه شباب الحاضر والمستقبل؟
المشكلة الخطيرة فيما يخص الأمور المتصلة بالخطابات الدينية، أنها لا تنقضى بانقضاء حيوات أصحابها، وتجاهلها لا يعنى أننا فى منأى عن آثارها، سلبية أو إيجابية، فالشيخ ابن تيمية عبر إلى الآخرة قبل 7 قرون تقريبا، وما زال حاضرا بقوة وحاكما لكثير من رؤانا الفقهية وشؤون ديننا ودنيانا، فهل الشاب الذى يقرأ فى "مجموع الفتاوى" أن ابن تيمية يقول إن من يجهر بتكبيرة الإحرام فى الصلاة يُستتاب وإن أصر على موقفه يُقتل، مضمون لدينا ألا يتورط فى هذا الطرح؟ وماذا عن مئات الشباب الذين تورطوا مع الإخوان والقاعدة وداعش بسبب هذه الخطابات المنتزعة من سياقها وتاريخها، والتى لم يواجهها أحد بالكشف والتفنيد؟
فى آراء الشعراوى وفتاواه أعاد إنتاج كثير من أفكار ابن تيمية وابن القيم، فاستشهد بهم مثلا فى رفضه لعمل المرأة وتعليمها واختلاطها، وفى تحريمه لتهنئة المسيحيين بأعيادهم، وهى أمور تتصل بحاضرنا ونعانى جانبا منها مع جماعات دينية متطرفة، تعيد إنتاج هذه الخطابات لتستحلّ دمنا من خلالها، فماذا لو تجاهلناها ووجدها شاب متديّن محبّ للشعراوى فى حلقاته أو مقالاته أو حواراته؟ وماذا عن السلفيين الذين يرونه منقوص الإيمان ومشكوكا فى عقيدته؛ لأنه يُقرّ الصلاة فى المساجد القائمة على أضرحة، وأُقيم له ضريح فى مسقط رأسه، قرية دقادوس بمحافظة الدقهلية، بناء على طلبه كما يقول البعض، وبتطوّع من أبنائه كما يقول آخرون، أليس الاقتراب من هذه النقطة وتفنيدها يحفظ للشيخ كرامته فى وجه خطاب سلفى يطعن فيه فى دوائر الجماعات السلفية وأمام تلاميذها؟ وأليس من الغريب والداعى للشك أن السلفيين الذين يشكّون فى عقيدة الشعراوى بسبب الأضرحة، هم أنفسهم من يستخدمونه وسيلة للمزايدة على الآخرين الآن؟ هل هذا استغلال غير برىء منهم لشعبية الرجل؟ أم لأنه فى الوقت نفسه تبنّى رؤاهم المتشددة فى أمور أخرى فقهية وشرعية، وفى بعض التفاصيل التى تخص صفات الله والاستواء، وهو باب خلاف كبير بين الأشاعرة والمعتزلة والسلفيين التيميّين؟
كل هذه الأمور وغيرها مُوجِبة للسؤال والبحث، للوصول لمزيد من الفهم، وتحرير شخصية الشعراوى من الأساطير التى ينسجها حوله المحبون والكارهون، ولا إهانة فى أن نستعيد مواقفه التى اتخذها كبشر فى سياقات وظروف، كأن يقول مثلا فى حوار مع جريدة اللواء الإسلامى بالعام 1987 إن أحمد صبحى منصور وجماعة القرآنيين، يُعاقبون بحدّ الحرابة، أى تقطيع الأرجل والأيدى من خلاف وصولا إلى القتل، ثم إفتائه بعد ذلك بسنوات بأن من حق المواطنين تطبيق الحدود حال تعطيلها، وكون هذا جاء بالتزامن مع قتل فرج فودة على أيدى متطرفين إسلاميين، وكان شريكا فى هذا الموقف الشيخ الإخوانى وصديقه القديم محمد الغزالى، الذى تطوع للشهادة أمام النيابة وكتب مقالا صحفيا قال فيه إن قتلة فرج فودة يُعاقَبون بالتعزير لأنهم افتأتوا على حق ولى الأمر، ولكنهم قتلوا مرتدا يستحق القتل، هذا أمر لا يمكن تجاهله، ويتعيّن علينا الوقوف عنده وقراءته، لفهم خلفيات الموقف وبواعث الشيخ لاتخاذه، ولتفنيد "فقه الدم" الذى نتورّط فيه الآن ويحرق فى كل يوم مزيدا من شبابنا.
الشيخ الشعراوى تلقّى تعليمه بشكل مجانى، ولكنّ له موقفا صريحا يقف فيه بشراسة ضد مجانية التعليم ويهاجمها، إذ قال فى حواره مع سناء السعيد المنشور فى كتاب "الشعراوى بين السياسة والدين"، إنه غريب وغير مفهوم أن تُعلّم مصر الأغلبية بالجامعة وهى من دول العالم الثالث، ونص كلامه: "من قال إن دولة متخلفة فى العالم الثالث، ما زالت فى بدء المحاولات لكى تنهض، تشرع بمهمة توظيف كل أفرادها، وتأخذ على عاتقها تعليم الأغلبية بالجامعة، فدعونا من نفاق الجماهير ولنشرع فى علاج مثل هذه القضايا بروح جديدة"، هل هذا الموقف يمكن أن يكون قراءة موضوعية لسياق التعليم؟ وهل يتفق التربويون معه أم يختلفون؟ وهل تكون هذه الفكرة حلا لأزمة التعليم؟ كلها أسئلة مهمة وتستحق التوقف، حتى لو كان فى موقف الشيخ شىء من التناقض، فأن تراها انتقادا له هذا أمر يخصك، ولكن غيرك قد يراها محاولة للبحث والفهم.
هل لو استعدت ما رواه الشعراوى عن استمراره فى التدخين حتى قبل وفاته بشهور، خلافا لما أورده بهاء الدين إبراهيم فى مسلسل "إمام الدعاة"، يمثل إهانة للشيخ؟ أم إنهاء لحالة من عدم الأمانة فى نقل تفاصيل حياته لمحبيه؟ وهل يمكن أن يضعنا هذا أمام طرح فقهى مغاير لما يردده الأزهريون ورجال الدين عن حُرمة التدخين؟ أم أنه مجرد تناقض عابر وتجاوز من الشيخ لحكم شرعى؟ أسئلة مهمة لا يمكن إثارتها بغير الكشف عن هذه المعلومة التى جرى إخفاؤها بشكل متعمد، وشخصيا التقيت الدكتور بهاء الدين إبراهيم مؤلف المسلسل، وسامى الشعراوى، نجل الشيخ، فى ندوة خلال سنة إذاعة المسلسل 2003، وسألتهما عن الواقعة، ولم ينفها أى منهما، وإنما اتفقا على رد واحد حول تجاهلها فى المسلسل، وهى أنهما كانا يصنعان نموذجا وقدوة للشباب وهذه المعلومة تافهة ولن تفرق مع الناس، هذا مبررهما غير المقنع لى وقتها، فهل من أخفى معلومة مهمة كهذه، تحدث عنها الشعراوى نفسه لمحمد زايد فى كتاب "مذكرات إمام الدعاة"، هو من يزدرى الشيخ وحياته؟ أم من يُحرّر الوقائع سعيا إلى الفهم وإنزال الرجل منزلته العادية كإنسان له ما له وعليه ما عليه؟
تقديس الإسلام أم تقديس الشعراوى؟.. هكذا يمكن أن نُقيّم مواقفنا
النقطة الأكثر خطرا من كل الملاحظات وعلامات الاستفهام التى يمكن أن يسجلها أى قارئ أو مُطّلع أو ناقد لسيرة الشعراوى، أو يتجاوزها أى محبّ أو مُقدّس له، هى خطاب الشيخ الراحل نفسه، وهو خطاب يمكن أن يلحظ فيه البعض ارتباكا واهتزازا واضحين، إذ يمزج الاستدعاء من حقول مختلفة ومتضاربة أحيانا، مع استشهاد بأحاديث ومرويات ضعيفة أحيانا، وذلك بقدر من الروحانية والليونة والتبسّط، مُورّطا قطاعا لا يُستهان به من الناس فى الإعجاب، فالتوحد والتماهى معه، وصولا إلى التقديس، وهذا ما تحقق بالفعل، ولا يمكن لنظرة منصفة أو درس اجتماعى محايد أن ينفيه، الشعراوى اكتسب هالة تتجاوز حدّ ما للإنسان العادى من تقدير، وتقترب من هالات القداسة والعصمة، وكثيرون من مُقدّسى الرجل هم أنفسهم من ينتقدون الطبيب الراحل مصطفى محمود والدكتور زغلول النجار وأمثالهما، رغم أن الشعراوى كبير هذا الباب الذى فتح دوّامة الإعجاز العلمى فى القرآن بما فيها من ملاحظات ومناطق لبس وثغرات تفخيخ للخطاب الدينى وعصمته، بربطه بنظرية علمية قابلة للتطور والتغير، كما أنهم ينتقدون عمرو خالد ومصطفى حسنى ومعز مسعود، رغم أنه كبير هذا الباب الذى بدأ المسلك العاطفى التبسيطى لأمور الخطاب الدينى، ولكن إلى جانب هذا فلا يخلو خطاب الشيخ الشعراوى من رؤى فقهية متورطة فى العنف وفقه الدم، وفلسفته عن التجديد تنحصر فى مجرد إعادة قراءة تراث الفقه بلهجة جديدة أو "تون" صوت وانفعالات وجه وملامح عصرية، لكن الاشتباك الحقيقى مع الخطاب نفسه وركائزه، ومحاولة تجاوزه بشكل يوافق بين الأصول العقدية وتعقيدات الواقع، محاولة إنتاج خطاب عصرى متمدّن مستجيب لجوهر الدين وتعقيدات الحاضر، محاولة مصالحة الإسلام المدوّن فى كتب الأسلاف بسياقاته التاريخية وظروف عصره على الإسلام الإنسانى السمح الصافى، وتعقيدات الراهن الذى نحياه، ومصالحة الدين على العلم، هذه المحاولات المهمة والضرورية ربما لا تجدها إذا بحثت عنها فى خطاب الشعراوى، ولكنك ستجد تداخلا فى المناهج والأفكار والمدارس، يراه البعض موضوعية وسِعَة أفق، ويراه آخرون تناقضا وغيابا للمنهج ومحدودية للرؤية، الرؤيتان فى ذاتهما مقبولتان فى حق إنسان عادى، دون تقديس مبالغ فيه، أو تدنيس يفتئت على الرجل، ومن يتورط فى التقديس أو التدنيس، ويتجاهل المعلومات الموثقة وما رواه الرجل عن نفسه، يحتاج للتوقف برهة واستعادة كلمة الصحابى الجليل أبى بكر الصديق: "من كان يعبد مُحمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإنه حى لا يموت".
.jpg)
خلاصة الأمر، الشعراوى فى ذمة الله، ولكنه حى بخطابه، والانتقاد - أى انتقاد - هو للخطاب لا الشخص، وما يسرى على الشخصية العامة لا يسرى على عموم الناس، والحقيقة القاطعة أن الرجل إنسان عادى، له ما له وعليه ما عليه، لديه إيجابيات ولا يخلو من السلبيات، ومحاولات تقديسه وتأليهه ضارة به، وهو نفسه لم يطلبها أو يسعَ إليها، كل ما فى الأمر أنه اجتهد لتقديم تفسير لغوى وبلاغى للقرآن، مستعيدا تراث التفاسير بشكل بسيط وغير معمّق، لم يُضف كثيرا أو جديدا فى حقيقة الأمر، مع محاولة جاءت متعسفة فى كثير من الأحيان لربطه بالنظريات العلمية الحديثة، وفى رحلته الطويلة استهلك الرجل أفكار ابن تيمية وابن القيّم والأشاعرة والمعتزلة والمتكلمين والمتصوفة ومحمد بن عبد الوهاب وأبو الأعلى المودودى ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وحسن البنا، دون فرز أو تأسيس لمنهج واضح ومتماسك، ويبدو أنه كان ينقل كل ما ترتاح إليه نفسه، وليس كل متعرّض لسيرته مجبرًا على قبول ما قبله، أو سلوك ما سلكه، أو تنزيه ما نزّهه، أو مدح مَن مدحهم، المهم أن يكون الانتقاد فى حدود المعلومة الثابتة والتقدير الموضوعى، ودون إهانة للشخص وحريته فى اختيار مواقفه، ولكن هذه الحُرمة وتلك الحرية لا تعنيان أن يُسلب حقُ الآخرين فى النقد والفرز والتقييم، وفريدة الشوباشى مارست حقها، ولم تزدرِ الإسلام، لأن الشعراوى - رحمه الله - ليس الإسلام.
.jpg)